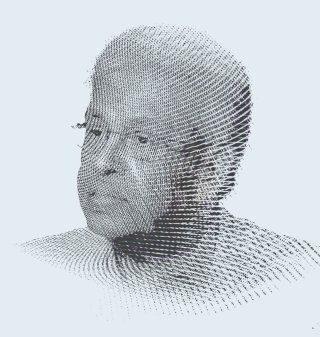«الإصلاح» يبدو مفهوماً وسطاً ما بين مفهوم «المحافظة» المتهم دائماً بالرجعية التي تحافظ على الأوضاع القائمة وربما تدفعها إلى الجمود والتطرف الفاشي، ومفهوم «الثورة» الموسوم دائماً بالراديكالية الذي قد يندفع إلى الفوضى القائمة على غرائز الجمع وليس مستبعداً أن ينتج دولاً فاشلة. «الإصلاح» مع ذلك يظل مفهوماً محورياً يجمع بين التغيير بحيث لا يصل إلى التطرف، والتدرج بحيث لا تضيع معه الفرصة. الموضوع هنا استمرار لما جاء في هذا المقام عن «طريق الإصلاح العربي»، حيث اقتنص عدد من الدول العربية طريق الإصلاح من بين براثن الفوضى التي أفضت إلى حروب أهلية، وأسنان التطرف الديني الذي قاد إلى الإرهاب. مجموعته حتى الآن من الدول العربية تضم دول الخليج العربي وكلاً من مصر والأردن والمغرب، بينما لا تزال الجزائر والعراق وتونس تحاولان استيعاب اللحظة واتخاذ القرار. القضية المهمة هنا تدور عن الكيفية التي يمكن بها لدول الإصلاح العربي التعامل مع الحالة الراهنة للحروب التي بدأ بعضها مع «الربيع العربي»، وبعضها الآخر جاء وتفرع عن حرب غزة الخامسة الممتدة إلى الحدود الإسرائيلية مع لبنان وسوريا والضفة الغربية، والحروب الإقليمية الدولية التي تتحارب فيها الولايات المتحدة مع إيران بوسائل كثيرة تظهر تارة حول السلاح النووي، وتارة أخرى تستعير التعاطف العربي مع الفلسطينيين بأشكال مختلفة لتعطيل الملاحة والتجارة الدولية عن طريق الحوثيين في البحر الأحمر، أو عن طريق قوات «الحشد الشعبي» العراقية ضد القواعد الأميركية في سوريا والعراق والحدود السورية الأردنية.
إذا كانت دول الإصلاح العربي قد بدأت مسيرتها بحزم مع منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين فإنها بعد عدد من الصدامات الحادة التي دارت حول إيران، استقرت على تعاملات هادئة في السياسة الخارجية مع مطلع العقد الثالث. ولعل إعلان العلا الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي في يناير (كانون الثاني) 2021، والذي ترتب عليه عملية إصلاح واسعة في السياسات الخارجية مجالها فض الخصومات الإقليمية مهما بدت مصادرها صعبة، ومهما كانت إشكالياتها معقدة. الحصاد كان جيداً، فقد جرت عمليات التهدئة والتصالح بين دول عربية وقطر، وجرى بينها تصالح آخر مع تركيا، وتمكن الصينيون من فتح العلاقات السعودية – الإيرانية، وبعدها جرى فتح العلاقات بين طهران وكلٍّ من أبوظبي والقاهرة. بات الوقت زمناً للتهدئة والاستكشاف وحل مشكلاتها على مهل مصحوباً بكلمات طيبة. باتت الحكمة الذائعة في إقليم الشرق الأوسط تقوم على وقف التصعيد، والتهدئة بنزع حدة الصدامات، ومحاولة وجود اقتراب من القضية الفلسطينية وحل الصراع مع إسرائيل.
وكان السلام الذي قامت به كل من مصر والأردن من قبل، والذي تراوح دائماً بين البرودة والدفء حسب ما يقضي به «ترمومتر» العلاقات الإسرائيلية مع الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين. كان ذلك هو الوقت الذي بدأ فيه سلسال حروب غزة ولبنان المتتابعة والتي ظهرت فيها الصواريخ الإيرانية في ساحة المعركة. لم تكن هذه الصواريخ بعيدة عن تلك التي استخدمت من قبل الحوثيين في الجزيرة العربية فيما بعد.
حتى 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدا أن تيار التهدئة الإقليمية العامة مثمراً، بل برزت إمكانيات التعاون الاقتصادي والسياسي؛ هو المسار المُبشر لمنطقة تتخلص تدريجياً من المشاحنات والمكايدات والاحتكاك غير الضروري، وتذهب في اتجاه البحث عن فرص جديدة للازدهار والأمن. واحدة من هذه الفرص كانت التطبيع بحيث تقع على مسار تنفيذ المبادرة العربية للسلام، وتحقيق طريق مضمون لقيام سلام إسرائيلي فلسطيني يقوم على حل الدولتين. وكان معنى ذلك أن تتعمق العلاقات السعودية – الأميركية التي كانت تسعى بعد فشل إدارة بايدن في استعادة الاتفاق النووي الإسرائيلي إلى تحقيق نجاح يحقق السلام والأمن والاستقرار الإقليمي في حل مشكلة عانت منها أجيال جديدة في المنطقة والعالم. أحداث 7 أكتوبر قلبت الحال الشرق أوسطي رأساً على عقب، وما ظهر منه لا يزال أقل كثيراً مما خفي.
ولكن الظاهر كان يشير إلى أن إيران وأعوانها باتوا عازمين على إحباط المسار الإصلاحي للعلاقات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط، ووضعها مرة أخرى على سيف القضية الفلسطينية. وقعت إسرائيل في الفخ الإيراني، وتركت نفسها لتيارات متطرفة وأصولية يهودية حاولت استغلال الموقف في اتجاه عدوان هائل ووحشي على الشعب الفلسطيني في غزة. وفضلاً عن الجرائم النكراء في الحرب، فإن تهديداً لمصر نشأ من محاولات التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، وتهديداً آخر بنشوب حرب إقليمية تشمل سوريا ولبنان والعراق، وتهديداً ثالثاً لأمن الملاحة والتجارة في البحر الأحمر والمرور في قناة السويس.
الأزمة الكبرى التي تولدت عن كل ما سبق وقفت في مواجهة ما دفع به الإصلاح في السياسات الإقليمية خلال المرحلة السابقة مباشرة للحرب في غزة وتوابعها، وهو الذي كان صادراً من استراتيجيات إصلاحية في الداخل تغير من البنيات السياسية والاقتصادية والثقافية للدول. المنعطف الحالي إذن ليس موجهاً فقط للسياسات والمواقف الخارجية للدول العربية، وإنما المنهج الإصلاحي المتبع في إدارة الدول ودفعها إلى التقدم. المواجهة إذن، تبدو أكثر عمقاً مما تبدو عليها صداماً آخر بين معسكر المقاومة والممانعة والمواجهة الشاملة مع إسرائيل والغرب، وآخر عكس ذلك، وإنما هي تدخل في صميم المواجهة الفكرية والعملية بين من يريدون البناء والتنمية والرقي الفكري والتكنولوجي، وهؤلاء الذين يريدون لبلادنا أن تظل دائرة في نفس الطاحونة التي دارت بنا طوال العقود السابقة.
نقلا عن الشرق الأوسط